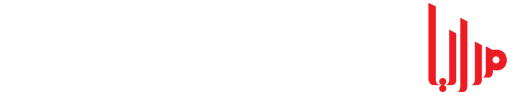التحدي الباقي أمام الفلسطينيين، وأمام قيادتهم، يتعلق أساسا بإعادة بناء كياناتهم السياسية، على أسس جديدة، وإعادة الاعتبار لحركتهم الوطنية باعتبارها حركة تحرر وطني ضد الاستعمار والعنصرية، بعد أن غرقت في وضعيتها كسلطة.
من غير المتوقّع من اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (14 و15 يناير الجاري)، الذي بدأ في رام الله، أن يأتي بنتائج أفضل من سابقه، الذي عقد قبل ثلاثة أعوام (مارس 2015)، وهو الذي خصص للبحث في سبل مواجهة التداعيات الناشئة عن اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها. فقد اتخذ هذا المجلس، في اجتماعاته السابقة، العديد من القرارات ومن ضمنها مثلاً إجراء انتخابات جديدة للرئاسة والمجلس التشريعي، بعد أن انتهت الفترة التشريعية، ولتلافي أزمة الشرعية، إلا أن هذا لم يحصل، كما في الدعوة لتحقيق المصالحة الوطنية، وهو أمر مازال يتعثر، سواء من فتح أو من حماس. وفي الدورة الماضية (2015) تحديدا اتخذ المجلس المركزي قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد انهيار عملية المفاوضات، وإصرار إسرائيل على الاستمرار بالاستيطان وشنها الحروب على غزة، إلا أن هذا القرار ظل حبرا على ورق.
لذا وبالقياس على ما تقدم فإنه ليس من المرجح أن يتوصل المجلس المركزي إلى اتخاذ قرارات حاسمة، وذلك لعدة أسباب، أولها، أنه لا يملك، من الناحيتين التمثيلية والفعلية، تقرير السياسات أو الخيارات الوطنية الفلسطينية، التي يتحكّم بها الرئيس، أي رئيس السلطة والمنظمة و(فتح)، مع مجموعة من القياديين، بمعنى أن المجلس مستدعى فقط للتغطية على بعض التوجهات.
وثانيها، لأنه لا يملك أيّة سلطة شرعية أو مؤسسية وذلك بسبب تقادمه، وبحكم أفول معظم الفصائل المشاركة فيه، وأيضا بواقع تهميش منظمة التحرير، علما أن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية (وبحاجة إلى تجديد)، لم يعقد أي جلسة له منذ عام 1996، وبديهي أنه لا يمكن للمجلس المركزي أن يحل محله. وثالثا، لأن أوضاع السلطة الفلسطينية غير مهيّأة لأي خطوة دراماتيكية، تخرج عن السياق العام الذي سارت عليه منذ إقامتها، وفقا لاتفاق أوسلو، فهي لا تملك عناصر القوة اللازمة لذلك، ولا القدرة لإنفاذ قراراتها بحكم شبكة الاعتمادية التي تربطها بإسرائيل، وبحكم اعتمادها في مواردها على المعونات الخارجية، ولا سيما بواقع وجود طبقة سياسية فلسطينية بات من مصلحتها الاستمرار في هذا المسار، بغض النظر عن الأثمان المترتبة عليه، على صعيد القضية الفلسطينية والمصلحة الوطنية للفلسطينيين.
على أيّة حال فإن مجمل التوقعات تتركز على أن ردة الفعل على القرار الأميركي، وعلى إصرار إسرائيل الاستمرار في إنشاء المستوطنات في الضفة وفي القدس تحديدا، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، لن يتجاوز توجهين؛ الأول إعلان التخلص من اتفـاق أوسلو، علما أن إسرائيل كانت أشبعته قتـلا، أو تملصت جملـة وتفصيلا منه منذ زمن طويل، مرت خلالها الخطة العربية للسلام (بيروت عام 2002) وخطة “خارطة الطريق” (2002)، وتوافقات أنابوليس (2007)، والمفاوضات المباشرة (2013 – 2014)، وكلها قتلتها إسرائيل بالغطرسة والتعنت والرفض. والثاني هو إعادة النظر بوظائف السلطة الفلسطينية، وضمن ذلك وقف العملية التفاوضية، واعتبار أن السلطة معنية بإدارة أحوال الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في أرضه، وذلك بدلا من إعلان حل السلطة، وتسليم المفاتيح لإسرائيل؛ على نحو ما تحدث عنه سابقا الرئيس الفلسطيني بذاته مرارا، باعتبار أن ذلك هو ما تريده إسرائيل وأنه لذلك يجب التمييز بين حل السلطة وتغيير وظائفها.
على أيّة حال، فإن تغيير وظائف السلطة ليس أمرا هينا على ضوء ما ذكرناه سابقا، أي بحكم علاقات الارتهان والاعتمادية التي تربطها بإسرائيل، سواء كانت المالية أو التي تتعلق بشبكة البني التحتية أو بحكم سيطرة إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع في الضفة الغربية، ناهيك عن الالتزامات السياسية والأمنية. كما أن هذا الأمر يجب أن يأخذ في الاعتبار الضغوط الأميركية، ولا سيما أن إدارة ترامب تبدي انحيازا واضحا لإسرائيل، علما أن الولايات المتحدة تقدم للفلسطينيين حوالي مليار دولار سنويا، إن كان عبر السلطة أو عبر وكالة الأونروا أو عبر مساعدات غير مباشرة، وهو مبلغ يشكل ربع موازنة السلطة الفلسطينية، بمعنى أنها مع إسرائيل تسيطر على ثلاثة أرباع الموارد المالية المتدفقة على السلطة.
ليس القصد من هذا الكلام تثبيط الهمم، أو القول إنه ليس لدى الفلسطينيين ما يفعلونه إزاء هذه الضغوط، وإنما القصد الإشارة إلى مكامن الصعوبة التي تتعلق بقدرتهم على مواجهة التحديات المذكورة، أو التي تتعلق بتغيير المعادلات السياسية، التي سادت منذ إقامة السلطة (1993)، ولا سيما مع علمنا أن القيادة الفلسطينية غير مهيّأة، ولم تهيّئ شعبها لمواجهة كل ذلك، خاصة مع تآكل الكيانات السياسية السائدة منذ زمن، وانحسار قدرتها في مواجهة إسرائيل.
هكذا فإن التحدي الباقي أمام الفلسطينيين، وأمام قيادتهم، يتعلق أساسا بإعادة بناء كياناتهم السياسية، أي المنظمة والسلطة والفصائل والمؤسسات والمنظمات الوطنية الجمعية، على أسس جديدة، وإعادة الاعتبار لحركتهم الوطنية باعتبارها حركة تحرر وطني ضد الاستعمار والعنصرية، بعد أن غرقت في وضعيتها كسلطة.
ولعل أهم ما يجب إدراكه، أو الاعتراف به، هنا، أولا، أن قيام كيان فلسطيني، في الأراضي المحتلة عام (1967)، لم يحسّن أحوال شعب فلسطين، ولم يقرّبهم حتى من تحقيق هدفهم المتعلق بدحر الاحتلال، إذ بحسب اعترافات قادة السلطة أنفسهم، فقد تضاعف حجم الاستيطان في مرحلة “أوسلو”، وبات الفلسطينيون أقل حركة في بلادهم من ذي قبل، فقطاع غزة يخضع للحصار، وأضحت الضفة، التي كانت وحدة جغرافية متواصلة، مقطعة الأوصال، بواسطة الحواجز العسكرية والمواقع الاستيطانية والجدار الفاصل والطرق الالتفافية، ما يفيد بتآكل جغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين، واستهلاك حركتهم الوطنية، أو تفريغها من مضمونها، بتحويلها إلى مجرد سلطة تخضع للاحتلال أو تتعايش معه.
ثانيا أن هذا الكيان يعيش على هامش التوافقات الأميركية – الإسرائيلية، ووفق الحدود التي يقدرها هذان الطرفان، طالما أن الفلسطينيين غير قادرين على قلب الطاولة، أو تغيير قواعد اللعبة، أو غير راغبين في ذلك، وطالما أن المعادلات العربية والدولية القائمة مستمرة.
بديهي أن هذه صورة لا تدعو إلى التفاؤل، باجتماع مجلس مركزي أو من دونه، لكنها تحرض على نبذ الأوهام، وضمنها وهم الدولة المستقلة في هذه الظروف، والبحث عن صيغ أخرى موازية أو مغايرة، مع إدراك أن الفلسطينيين يعيشون في واقع دولة (ثنائية القومية) لكنها دولة استعمارية وعنصرية.